
أفق – حسن شامي*
على مدى أسابيع متتالية، منذ 17 تشرين ثاني (نوفمبر) 2018 وحتّى اليوم، تعيش فرنسا هاجِساً يوميّاً، هو الخوف من اهتزاز استقرارها الداخليّ، الذي أثارته الحركة الاحتجاجيّة الواسِعة: حركة السترات الصفر. أشعلت الضرائب على الديزل والبنزين، التي اقترحتها حكومة ماكرون، فتيل تلك “الثورة”، ليتكشَّف مدى الضرر الذي لحق بفئات واسعة من الشعب الفرنسي، ” نتيجة تراكُم تاثيرات أربعة عقود من اللّيبراليّة الاقتصاديّة، والتكيُّف الاقتصادي القسري مع مصالِح النُّخب”، على حدّ تعبير جان بيار لوغوف، عالِم الاجتماع الفرنسي الشهير.
لم يندهش جان بيار لوغوف لاندلاع الغضب الشعبي بهذا الشكل، ومن بروز “السترات الصفر” كظاهرة تحمل دلالات كثيرة، إذ تحوَّلت من حركة اجتماعيّة غير مسبوقة إلى أزمة سياسيّة، تُضعِف الدور الفرنسي أوروبيّاً، وتثير مَخاوف دول الاتّحاد الأوروبي التي يشهد عدد منها تحرّكات مُماثلة، تنتشر اليوم، وإن بأحجام أقلّ ممّا في فرنسا، وبأشكال وصيَغ وطروحات تختلف من بلدٍ إلى آخر.
تسلِّط محنةُ ماكرون في هذه المُواجهة الضوءَ على مشكلة صعبة: كيف يطبِّق القادة سياسات يُمكن أن تعود بالنفع على البيئة على المدى الطويل من دون تكاليف زائدة على الناخبين، وأن تضرّ بفُرص إعادة انتخاب هؤلاء القادة؟
في الواقع تقدِّم نتائج هذه السياسات جواباً سلبيّاً، إذ يتبيّن أنّ مزيداً من الضرائب التي تُفرض تحت عنوان الحفاظ على بيئة نظيفة، يجري توجيها لسدّ عجوزات الموازنات. ففي حالة فرنسا، مثلاً، من بين 34 مليار يورو (38.71 مليار دولار) تقرَّر أن تجمعها الحكومة على شكل ضرائب للحفاظ على البيئة في العام 2018، تمّ تخصيص 7.2 مليارات يورو فقط لاتّخاذ إجراءات بيئيّة.
في وجه أساسي من وجوهها، وإن لم يبرز هذا الوجه بوضوح كامل بعد، تبدو حركة السترات الصفر ردّ فعل صاخباً على ارتدادات الأزمات التي تعصف ببنيان الوحدة الأوروبيّة، على مختلف الصعد، الأمر الذي جعل مفكّراً فرنسيّاً بارزاً هو ثيبود كولين Thibaud Collin يقول من دون تردُّد إنّ السياسة الأوروبيّة التي تتبعها جميع الحكومات منذ العام 1980 هي أوّل سبب بنيوي لحركة السترات الصفر.
مثل هذا القول لا يجانب الصواب. فرنسا تسودها اليوم، كما تسود دولاً اوروبيّة أخرى، مخاوفٌ ثلاثٌ، هي: الخوف من فقدان السلطة والهَيبة في العالَم، والخوف من العواقب الاقتصاديّة والاجتماعيّة للعَولَمة، والخوف من انكسار الهويّة الوطنيّة. ولعلّ هذه المَخاوف هي التي تجمَّعت في وجدان قسم كبير من البريطانيّين، وكانت دافعهم للتصويت على الخروج من الاتّحاد الأوروبي BREXIT.
فقبل أقلّ من خمسة أشهر على موعد انتخابات البرلمان الأوروبي (مقرَّر إجراؤها في أيّار/ مايو هذا العام)، يرى العديد من المُراقبين والمُحلّلين وعن قناعة أنّ حالة أوروبا مُقلقة للغاية؛ وأنّ الاتّحاد الأوروبي الذي كان يُفترض أنّه يقدِّم للعالَم نموذجاً للسلام والاستقرار السياسي والازدهار، يمرّ بحالة كارثيّة. والجانب الأكبر في هذا القلق هو أن تنجح الأحزاب المُناهضة لأوروبا في كبْح جماح تعزيز التعاون وخطوات الاندماج، من خلال تواجد أقوى في البرلمان الأوروبي ومن خلال تسميتها مُمثّلين في المفوضيّة الأوروبيّة مُعارضين للاتّحاد الأوروبي، فضلاً عن مُمثّلي الحكومات في المجلس الأوروبي والمجلس الوزاري.
وسيكون لذلك كلّه تأثير سلبيّ على مَوقع الاتّحاد الأوروبي ودَوره المؤثِّر في العَولَمة اليوم. فدول الاتّحاد تُسهِم بنحو 20 % من الناتج المحلّي الإجمالي العالَمي. ودخلها القومي الإجمالي أعلى من دخل الولايات المتّحدة، وهي أكبر قوّة تجاريّة في العالَم، والمَصدر لأكبر للاستثمارات الدوليّة، حتّى مع استبعاد التدفّقات الداخليّة.
عقد الأزمات
من هذا المنظور يُصبح بالإمكان القول إنّ العاصفة التي يمرّ بها الاتّحاد الأوروبي منذ العام 2008 ليست مجرّد كساد اقتصادي بسيط، بقدر ما تسلِّط الضوء على استنفاد نموذج تكامل معيّن قدرته على تجاوُز الأزمة بمُعالجات ناجِعة. فالصورة تبدو اليوم وكأنّ التكامُل الاقتصادي والنقدي الذي يمتلكه الأوروبيّون منذ زمن طويل، مُهدَّد بأن يتقوَّض من أساسه، بفعل الثغرات الداخليّة التي تعبره. وفي هذا المعنى، ثمّة تساؤل مُقلق عمّا إذا كانت أوروبا الموحَّدة قد وصلت مرحلة الكهولة والترهُّل، في وقتٍ يصعب على المرء أن يُدرك أنّ هذه الأوروبا المتعطِّشة إلى كلّ شيء، لم تؤتِ ثمارها بعد، على الرّغم من عقود ستّة على قيام مشروع وحدتها.
والاقتصاد الذي يعاني ليس وحده ما يشكِّل قوام الأزمة التي تهدِّد كيان الاتّحاد الأوروبي. ثمّة سبب جوهري آخر، هو أنّ الاتّحاد منذ قيامه حتّى اليوم، لم يُراعِ القيّمون عليه أن تتماشى سياساته، على أرض الواقع، مع الخصوصيّات المحدِّدة لكلّ بلد. والواقع أنّ دخول عشر دول إلى الاتّحاد الأوروبي في أيّار(مايو) 2004 لم يكُن مصحوباً بحماسة شعبيّة، بل بهاجسٍ انتاب السكّان الغربيّين وقلق من المنافسة غير المشروعة من سكّان شرق القارّة.
توسَّع الاتّحاد من 7 إلى 28 دولة اليوم بشكلٍ ظهر أنّ العشوائيّة كانت طابعه، وأنّه جرى من دون الأخذ بعين الاعتبار آراء الشعوب المعنيَّة بهذا التوسُّع الاندماجي، الأمر الذي جعل أصواتاً مُنتقدة تتحدَّث عن “ازدراء أوروبا لشعوبها”، وتَستشهد بانقلابِ مزاج النّاخب الأوروبي، الذي شكَّل اختياره اليمين المتطرّف في إيطاليا مؤشّراً بالغ الدلالة على ما يُمكن أن تسلكه أوروبا المستقبل، من طريق التطرُّف والانسلاخ عن قيمها التاريخيّة… المؤشِّر الآخر أنّ حركة السترات الصفر في فرنسا جمعت النقيضَين الأكثر تباعُداً: اليمين المتطرّف واليسار المتطرّف.
وثمّة استطلاعات رأي كثيرة جرت لقياس مدى اقتناع مواطني دُول الاتّحاد بمفهوم المواطنة الأوروبيّة (أوروبا كمرجع مُشترَك للهويّة)، جاءت نتائجها متفاوتة جدّاً بين دولة وأخرى، وأظهرت أنّ هذه المُواطنة لم تتحقَّق بشكلٍ كامل بعد، ما يعني أنّ الحديث عن الذاكرة الأوروبيّة المُشترَكة لا يستند إلى قاعدة متينة بعد..
القيادة المفقودة
الضعف الأساسي للاتّحاد الأوروبي في هذا الوقت هو انقساماته الجيوسياسيّة الداخليّة، والاختلافات العديدة بين الدول الأعضاء فيه تظهر أنّه يعاني، من بين أمور أخرى، من غياب القيادة السياسيّة الداخليّة.
وعندما تبرز مسألة القيادة تظهر ألمانيا كمثال يُحتذى به لأنّ أداء الاقتصاد الكلّي فيها أفضل من أداء اقتصادات البلدان الأخرى. لكنْ، في الوقت الرّاهن، ألمانيا غير قادرة على مُمارسة هذه القيادة لوحدها، بعد أن فقدت الكثير من إمكانات القيادة و”الهَيمنة الإيجابيّة”. هنا تبرز الحاجة إلى قيادة ثنائيّة تتشارَك فيها برلين وباريس. وهذه مشكلة أخرى. فبعد عقود من التعاون الفرنسي الألماني، الذي أدّى دَوراً محوريّاً في دفْع الاندماج الأوروبي، وتطويره وتعزيزه، ترتفع اليوم أصوات من داخل النّخبة الفرنسيّة، تحذِّر من “نزعات” للهَيمنة الألمانيّة على أوروبا، وتدعو لمُواجهتها. وطبعاً ما كان لهذه الأصوات من صدى لولا الأزمات التي تعيشها فرنسا، عِلماً أنّ بلداناً أخرى في الاتّحاد الأوروبي تنظر بشيء من الحذر إلى التفاهمات الألمانيّة الفرنسيّة، مثل الدول الثماني في شمال وشرق أوروبا، التي أصدرت رسالة جماعيّة في صيف 2018 ضمَّنتها مُعارضتها لموازنة موحَّدة لمنطقة اليورو.
لقد تغيَّرت قدرات أداء الثنائي الألماني الفرنسي وأشكاله. والمُفارَقة أنّه في وقت يُواجه الاتّحاد ضغوطاً كبيرة من الداخل والخارج على السواء، يصبح معها دَور التعاون الفرنسي الألماني أكثر ضرورة من أجل تعزيز الاتّحاد الأوروبي وتطويره، وخصوصاً في المجالات التي يتعرَّض فيها للانهيار، فإنّ المحيط السياسي الأكثر تعقيداً يجعل من هذا التعاون أكثر صعوبة وأكثر خلافيّة.
أمّا العقبة التي يقف عندها المتصدّون لمُعالجة سريعة للأزمة، فيختصرها السؤال التالي: أيّ السيناريوهات أفضل… انهيار الاتّحاد أو بقاء الوضع الرّاهن على حاله، أم تعزيز التكامل؟
هل مِن مَخرج؟
هناك إجراءات وإصلاحات ضروريّة، منها مثلاً على صعيد سياسة الهجرة والأمن الداخلي والخارجي، أو ضمن منطقة اليورو، من أجل إتمام الاندماج المنقوص الذي تمّ التوصّل إليه في العقود الماضية، لكي ينعم الاتّحاد الأوروبي بمزيد من الاستقرار والازدهار ويمنح مزيداً من الأمن والأمان.
في ما يتعلّق بمنطقة اليورو على سبيل المثال، برلين وباريس تريدان الآن العمل من أجل إكمال الوحدة المصرفيّة، وتبنّي موازنة اليورو بحلول العام 2021، التي تتألّف من مساهمات قوميّة للدول وإيرادات ضريبيّة وتمويل أوروبي، وتقوم على أساس متعدّد السنوات. إلى ذلك تبرز الحاجة إلى تطوير آليّة الاستقرار الأوروبيّة (ESM)، من خلال تعزيزها الأدوات الماليّة، والعمل وفق تدابير آليّة الإنقاذ، التي تصون المسؤوليّة الذاتيّة وآليّات الرقابة. ولكن ذلك يبقى حلّاً وسطاً بين التكافل والمسؤوليّة الذاتيّة، بين منطق آليّة السوق وضرورة التدخّل السياسي، يسلك مساراً صعباً على طُرق فهْم وتفسير مُتبايِنة حول طريقة عمل منطقة اليورو. فمثلاً، النظرة الفرنسيّة القائمة على الطلب، تختلف بشكلٍ واضح عن نظيرتها الألمانيّة القائمة على العرض. وفيما يُثمِّن الرئيس الفرنسي ماكرون دَور الموازنة الموحّدة لمنطقة اليورو على اعتبارها أكثر أهميّة، ترفض الحكومة الألمانيّة آليّات النقل.
وعلى صعيد تعميق منطقة اليورو تبدو فرنسا أكثر إقداماً من ألمانيا على التعامل مع هذه المجموعة المكوَّنة من 19 دولة. على الجانب الألماني يغلب المَيل إلى تجنُّب انقسام السوق المُشترَكة بين منطقة اليورو والبلدان غير الأعضاء فيها.
وربّما يبلغ البعض حدّ الشماتة، لكنّ ذلك يدلّ على قصر نظر أحياناً. فالأزمة التي يمرّ بها الاتّحاد الأوروبي لا تعني فَشَلاً كليّاً للتجربة، بمقدار ما تشكِّل حافزاً على العمل لتعميق هذه التجربة وتحصينها. الهشاشة المُفرطة للاتّحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تأتي من تباينهما وانقساماتهما الداخليّة، ومن هشاشة القيادة الألمانيّة أو الفرنسيّة الألمانيّة. لذا تبرز الحاجة الملحّة لإيجاد نموذج أوروبي جديد أكثر كفاءة وأكثر قابليّة لكسْب ثقة المُواطنين الأوروبيّين أنفسهم ولغيرهم. وهذا يحتاج إلى إدراكٍ عميق لنقاط الضعف في التجربة الأوروبيّة، وتحقيق التكامل المتعمّق الذي سيؤدّي إلى زيادة الكفاءة.
أوروبا الموحَّدة أمام تحدٍّ كبير ليكون لها دَور متزايد دوليّاً، في نظام متعدِّد المَراكز عالَميّاً… الفشل المرير اليوم يُمكن أن يكون بمثابة دعوة للأوروبيّين كي يسألوا أنفسهم هل سيكونون أكثر قدرة على البروز بشكل جيّد في هذه “المعركة” من خلال البقاء مُنقسمين أو مُواصلة اندماجهم؟
*كاتِب وصحافي من لبنان


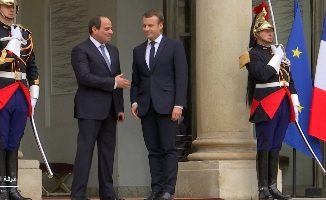

قم بكتابة اول تعليق