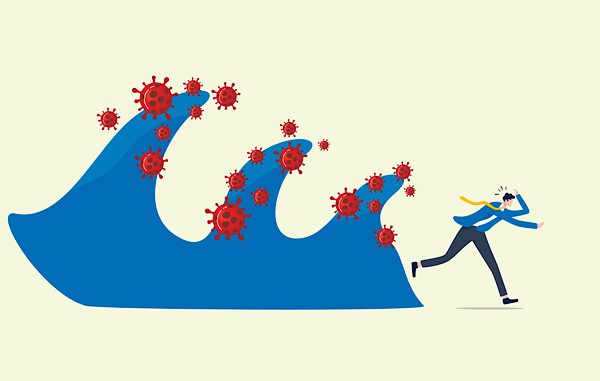
أفق – د. رفيف رضا صيداوي*
يبدو أنّ ظهور فيروس كورونا ما هو إلّا آخر جرس إنذار من بين تلك الأجراس التي أطلقتها كلّ الدعوات السابقة والرّاهنة، من فلسفيّة وسوسيولوجيّة وأنثروبولوجيّة وبيئيّة وغيرها، إلى ضرورة أنسنة العالَم، والتي لم تكُن قد لاقت إلى الآن آذاناً صاغية، على الرّغم من تنوُّع مَصادرها واتّجاهاتها… إلى أن نُكِب العالَم بوباء كورونا أو Covid-19، الذي قد يقود إلى تشكيل وعي عالَميّ جديد ربّما يكون، في حال نجاحه، قد حقَّق انتصار ثورة الطبيعة على ثورات البشر التي عرفها القرن الحادي والعشرون.
الكُتب والأبحاث، التي واكَبت التغييرات العالَميّة التي أحدثتها العَولمة منذ تسعينيّات القرن الفائت، ولاسيّما التغييرات السلبيّة على الأصعدة كافّة، توالت بالآلاف. عناوين مُتفرّقة ومَفاهيم جديدة مثل “خيبات العَولمة”، و”اختلال العالَم” وبربريّته وعُنفه وفوضاه، وكذلك حداثته “السائلة” أو “الفائضة” أو “الفائقة”…إلخ، أضحت صرخات مدوّية ضدّ “عالَم الميوعة” بثالوثه غير المقدَّس الذي يتألّف، بحسب صاحب مفهوم “الميوعة” أو”السيولة” زيغمونت باومان، من أقانيم ثلاثة: اللّايقين، فقدان الأمن، فقدان الأمان.
فيروس كورونا هو إذاً وليد هذا العالَم الذي تحتدم فيه الحروب واستخدامات الأسلحة النوويّة والسامّة والأزمات الماليّة والاصطفافات الطبقيّة، سواء داخل كلّ دولة من دول العالَم أم بين القارّات والدول، بقدر ما تزداد فيه المَخاطِر البيئيّة بفعْل استنزاف الكوكب وتدمير المحيط الحيويّ للأرض، وما يرافق هذه المظاهر كلّها من تدهورٍ في الظروف المعيشيّة للبشر المثبَت بمعدّلات الفقر. لكنّ هذا الفيروس المُتناهي الصغر، والذي يبلغ حجم جينوماته بين 26 إلى 32 كيلو قاعدة، نجح في شلّ العالَم وإزالة وهْم البشريّة المُتناهي الكِبر بامتلاك القوّة. ففيما نحن في بدايات ثورة صناعيّة رابعة تتوزّع تكنولوجيّاتها النّاشئة بين مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيويّة، وإنترنت الأشياء وغيرها، طفا البُعد الروحاني على سطح المُجتمعات العلمانيّة والدينيّة، المتقدّمة والتقليديّة، في دلالةٍ على حجم القلق واليأس اللّذَين أفضت إليهما ليبراليّة متفلّتة من أيّ معياريّة أخلاقيّة، بعدما أسرفت في تعظيم الذّات الفرديّة.
أمام خطر الموت الذي يؤذن به الفيروس، مَحت ردود فعل شرائح عريضة من الناس عقوداً من عقلانيّة الحداثة. أناس اليوم، كما أناس الأمس ردّوا الأمر إلى الغضب الإلهي، فلجأوا إلى الخالِق، طالبين الرّحمة والغفران، شأنهم في ذلك شأن الأوروبيّين حين داهمهم وباء الطاعون الدبلي (1347-1350) المعروف بـ “الموت الأسود”، وأهلك نحو ثلث سكّان القارّة؛ أو حين داهمَ الجدري العالَم في القرنَين الخامس عشر والسابع عشر، أو الكوليرا (1817-1823)، أو الإنفلونزا الإسبانيّة (1918-1919) التي أصابت نحو500 مليون شخص، وتسبَّبت في موت أكثر من 50 مليوناً على مستوى العالَم… ولم تكُن هذه العودات بمعزل عن تلك المُحاكاة لِما وَرَدَ في العهد القديم (التوراة) والإنجيل والقرآن حول العقاب أو الآخرة أو يوم القيامة ونهاية الزمان، بعد أن يكون الفساد قد استحكم بالمُجتمعات، فتغدو نهاية العالَم عِقاباً إلهيّاً مدوّياً؛ حيث وَرَدَ، في العهد القديم، على سبيل المثال لا الحصر: “فَهوَذَا يَأْتِي اليَومُ المُتَّقِدُ كَالتَّنُّورِ، وَكُلُّ الْمُستَكبِرِينَ وَكُلُّ فَاعِلِي الشَّرِّ يَكُونُونَ قَشًّا، وَيُحرِقُهُمُ الْيَومُ الآتِي، قَالَ رَبُّ الجُنُودِ، فَلاَ يُبْقِي لَهُمْ أَصْلاً وَلاَ فَرْعاً” (ملاخي 1:4)؛ فيما وردت علامات اليوم الآخر في العهد الجديد “وَلِلوَقْتِ بَعْدَ ضِيقِ تِلكَ الأَيَّامِ تُظْلِمُ الشَّمسُ، وَالقَمَرُ لاَ يُعطِي ضَوْءَهُ، وَالنُّجُومُ تَسقُطُ مِنَ السَّمَاءِ، وَقُوَّاتُ السَّمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ” (مت 24: 29)؛ أمّا عن الإيذان بفناء العالَم الدنيوي، فقد جاء في القرآن: “يَسأَلُ أَيَّانَ يَومُ القِيَامَةِ. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَجُمِعَ الشَّمسُ وَالقَمَرُ. يَقُولُ الإِنسَانُ يَومَئِذٍ أَيْنَ المَفَرُّ”(القيامة :5-10).
من أسطورة التفوُّق إلى الحياة كأسطورة
لئن دلَّ هذا التماثُل العابر للأزمنة والمُجتمعات والثقافات بين ردودِ فعل البشر على النكبات على شيء، فإنّما هو يدلّ على ديمومة الروحي والإيماني واندراجه في أصل حضارة الإنسان، على الرّغم من كلّ ما امتلكه إنسان الحداثة وما بعدها من قوّة وحرّية ومَعرفة، وتفوُّق وسيطرة، سواء على سائر الكائنات الحيّة أم على الطبيعة عموماً. فهذا الإنسان المتفوِّق أو السوبرمان النيتشويّ الذي قاده تطوّره إلى “أسْطَرَة التكنولوجيا” في هذا المجتمع الرقمي الحديث المحكوم بالتكنولوجيا، والذي أفضت حداثته إلى إعلان “موت الموت”، “واستبعاد أفقه وإزاحته بمهارة من الحياة اليوميّة” (بحسب الفيلسوف الرومانيّ الأصل Mario Ionuț Maroșan في مقالة له على موقع up-magazine نُشرت في (2020/3/16)، ما لبث أن لامَسَ ضآلته، ولاسيّما مع نيوليبراليّة وحشيّة تُمعِن في تجريده من كينونته، وفي اختزاله إلى مجرّد آلة استهلاكيّة، تتحدَّد قيمته بقوانين السوق، وذلك في سياق “عمليّة تصنيع الإنسان القابل للرمي La fabrication de l’homme jetable” على حدّ تعبير الشاعر والكاتب السياسي الفرنسي ايمي سيزر Aime Cesair. هذه السوق التي شدَّد Mario Ionuț Maroșan على مسألة إخضاعها الموت نفسه لقوانينها، أي كنشاطٍ إنتاجيّ يحتلّ حصّته فيها، وذلك باتّباع نموذج العرض والطلب، والامتثال للمُنافَسة التجاريّة.
وبقدر ما عبَّر فيروس كورونا عن انتفاضة الطبيعة ضدّ انتهاكات الإنسان لها، واستكباره عليها، هذا الانتهاك الذي عبَّر عنه مُصطلح “عِلم الأوبئة المتغيّر”، الذي اجترحه عالِم الأوبئة المصري عبد الرّحمن عمران لوصف عصرنا بكونه “عصر تحلُّل وأمراض من صنع الإنسان” (راجع: شلدون واتس، الأوبئة والتاريخ- المرض والقوّة والإمبرياليّة، ترجمة وتقديم أحمد محمود عبد الجواد، المركز القومي للترجمة، القاهرة 2010)، فتحَ الفيروسُ جردةَ حسابٍ ومُساءلةٍ لكلّ اليقينيّات التي أرستها اللّيبراليّة المتفلّتة من أيّ ضوابط؛ إذ إنّ الجانب الروحاني للإنسان، ببُعديه الإيماني أو غير الإيماني، شيء، والاستسلام للمنطق الغَيبي شيء آخر. وواقع الفوضى والاختلالات من كلّ نوع الذي أفضت إليه هذه اللّيبراليّة التي “لم تعُد تخاف من شيء” على حدّ تعبير الباحث الفرنسي فرنسوا كوسّيه François Cusset، يُحتّم علينا وضع الإصبع على الجرح، وتعيين مَكامن المرض؛ ومن هنا جملة المُراجعات والأسئلة من كلّ نَوع التي لا يتوقّف تداولُها في السياسة كما في الاقتصاد أو الفلسفة وغيرها من الحقول المعرفيّة.
في السياسة، جاء الفيروس ليُظهِر هشاشة المُجتمعات المتحضّرة والغنيّة، ولاسيّما في الولايات المتّحدة، لجهة احتواء الأزمة على المستويَين الصحّي والاجتماعي، كاشِفاً بذلك الغطاء عن الوعود الفارغة للديمقراطيّة اللّيبراليّة وحاثّاً على مُساءلتها. وفي الاقتصاد، سمح الفيروس بمُعاينة زيف الوعود بالرفاه كشعار أساس للّيبراليّةِ الاقتصاديّة، ولاسيّما أنّ هذه اللّيبراليّة بملامحها الرّاهنة زادت الاصطفافات الطبقيّة، سواء في أميركا والدول الغربيّة أم في دول العالَم الأخرى، أو بين الدول نفسها، ناهيك باشتداد التنافس كقيمة متحكّمة بسلوكيّات الأفراد والجماعات والدول في ظلّ اقتصاد سوقٍ مفتوح وبلا ضوابط. لا بل إنّ النشاط الاقتصادي الرّاهن لم يُساعد في تقارب الشعوب بقدر ما أظهر أنّه تتمّة للنشاط الاقتصادي للإمبرياليّة ومؤسّساتها الاقتصاديّة العملاقة التي شكّلت “فرصة سانحة لانتشار مُسبّبات الأمراض، وخلق بيئة وبائيّة مُلائمة لها، وذلك تحت شِعار “تنمية” المُجتمعات التي استعمرتها”(شلدون واتس، الأوبئة والتاريخ، م س). وتطول لائحة المُساءلات لتشملَ القضايا الأخلاقيّة والقيَميّة والثقافيّة والأيكولوجيّة…إلخ، لكنّ القاسم المُشترَك الذي تتقاطع عنده هذه المُساءلات كلّها يتمثّل في إعادتها الطبيعة إلى المركز الذي تستحقّه من الاهتمام والعناية، والتساؤل عمّا إذا كان فيروس كورونا تعبيراً عن ثورة الطبيعة على الإنسان، وعمّا إذا كانت هذه الثورة هي التي ستُحرِّره من غطرسته وتُعلِّمه ما لم يعلّمه إيّاه العِلم. فهل يتّجه العالَم إلى إعادة إحياء حركة إنسانيّة أكثر تجذّراً وعملانيّة تَستكمِل تلك التي شهدها القرن العشرون في النصف الأوّل منه بعد مُعاناته من ويلات الحربَيْن الأولى والثانية، وما ترتّب عن ذلك من دعوات إلى التعاوُن وضروراته والسِّلم وخيراته على البشريّة جمعاء؟ وماذا عن دعواتٍ كتلك التي نادى بها مثلاً أمثال وزير الخارجيّة الفرنسيّ الأسبق هوبير فيدرين Hubert Védrine حول إمكانيّة الانتقال من “الجغراسيا” إلى “الجغكولوجيا” لئلّا يضيع كوكب الأرض منّا وتضيع الكائنات الحيّة منه، وتحديداً البشر، والتي لا تزال غير موضوعة على محمل الجدّ؟
وهل إنّ ثورة الطبيعة ستُعلِّمنا أنّ الاجتماع البشري، كغريزة طبيعيّة قائمة بالفطرة لدى الإنسان، مشروطٌ ببقاء الأرض وبقابليّتها للحياة والنموّ، ولاسيّما بعدما باعَد فيروس كورونا بين الناس فارِضاً عليهم الوحدة والعزلة، وحَرَمَهم حرارة الاتّحاد ودفء التواصُل إلّا بأشكاله الافتراضيّة؟
وهل إنّ ثورة الطبيعة ستُعلّمنا أنّ مُواجَهة الموت كحقيقة لا مفرّ منها، شأن الولادة، لا تكون بنكرانه أو نَفيه، بل بتقبّله بوصفه شرطاً إنسانيّاً نداويه بما نضفيه على حيواتنا من معانٍ إنسانيّة وبما نصوغ من مَعارف تغتني بها الإنسانيّة؟
لقد اخترتُ إنهاء مقالتي بمقطعٍ من رواية “الطاعون” (1947) لألبير كامو، نظراً إلى وجه الشبه الذي يربط هذه الرواية الخالدة بأوضاعنا الحاليّة، والمُتمثِّل بالوباء والموت. يسأل الراوي في رواية الطاعون ماذا ربح الدكتور ريو (وهو شخصيّة رئيسة في الرواية) بعدما خسر صديقه تارو، ويجيب قائلاً: “لقد ربح فقط أنّه عرف الطاعون وأنّه يتذكّره، أنّه عرف الصداقة وأنّه يتذكّرها وأنّه عرف الحنان وأنّه لا بدّ أن يتذكّره يوماً. إنّ كلّ ما يستطيع الإنسان أن يربحه في معركة الطاعون والحياة هو المَعرفة والتذكّر”. فهل تُساعدنا هاتان السمتان الإنسانيّتان على إعادة تشكيل وعينا واستعادة إنسانيّتنا؟
*مؤسّسة الفكر العربي

قم بكتابة اول تعليق